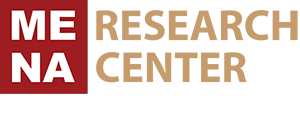ياسر حسون
الملخص التنفيذي:
يحاول الكاتب في هذه الورقة أن يضع يده على أساس العلة في العقل العربي الإسلامي؛ ليبيّن أنّ التجديد والإصلاح والتنوير يبدأ مما طرحه كأساس مُقَوَّمٍ لنهضة هذا العقل؛ الذي يتخبط في إدراك سبل الخروج من شرنقة التخلف والجهل؛ التي تُنْسب زوراً وبهتاناً للدين الحنيف؛ والدين منها براءٌ كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب.
فبعد مقدمة استهلالية لبيان أصل هذا التكلس في العقل العربي؛ يذهب مشخصاً العلة من خلال أقانيم ثلاثة، هي النقل والحفظ والإملاء؛ حيث يرى الكاتب بأنها علة العلل، ثم يعالجها مبيناً أثرها على نهضة وتقدم هذه الأمة التي تستحق مكانة أفضل بكثير مما هي فيه أو عليه؛ خصوصاً وأنها تمتلك مقومات وأساسيات النهضة والتقدم، لتؤدي رسالتها العالمية.
هذا كله يناقشه الكاتب من خلال المحاور التالية:
المحاور:
- المدخل
- هل يمكن للجماعات الدينية أنْ تتبنى حكماً ديموقراطياً؟
- ما سبب تجذّر الاستبداد والدكتاتورية في ثقافتنا؟
- ثالوث السبات الذي يعيشه العقل العربي الإسلامي!
- الركن الأول النقل!
- الركن الثاني الحفظ!
- الركن الثالث الإملاء!
- نتائج هذا الثالوث على العقل المسلم!
- الحرية هي الضحية!
المدخل
بعد الزلزال المدوّي الذي حصل يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 في سوريا، وسقوط الطغمة الحاكمة التي أحكمت سيطرتها على البلاد لأكثر من نصف قرن، أفاق السوريون على خبر لا يصدق، لقد سقط النظام وهرب الديكتاتور!
مشاعر الفرح العارم التي اجتاحت السوريين جعلتهم يتناسوا، أو يتجاهلوا كل صيحات التحذير بأن القادمين من إدلب هم فصيل إسلامي متشدد! بل لقد تغافل السوريون حتى عن أصوات الانفجارات التي سببها القصف الإسرائيلي المتواصل لكل ما له علاقة بجيشهم، الذي دأب على قتلهم؛ وتدمير مدنهم طيلة أربعة عشر عاماً. هذا الجيش الذي أصبح الآن يشكّل خطراً على جارتهم اللدود إسرائيل. وكأنها تقول لهم وللعالم أجمع: لقد ذهب الحارس الأمين ولا أستطيع السكوت عن أية قوة عسكرية في بلادكم. ومع ذلك، واظب السوريون على النزول إلى الساحات؛ وهم يرقصون على أصوات الأغاني والهتافات، فرحين ببلدهم الذي تحرر من الدكتاتورية؛ وعاد إليهم.
هل يمكن للجماعات الدينية أنْ تتبنى حكماً ديموقراطياً؟
الآن، وبعد مضي كل هذا الوقت على الأفراح بزوال تلك العصابة التي نهبت وقتلت وشرّدت ودمّرت، علينا أن نتوقف قليلاً للتفكير في المستقبل، ونسأل عن البديل: هل تخلص الشعب السوري من الاستبداد السياسي، وطغيان تلك الطغمة التي كانت تتلطى خلف شعارات بريئةٌ منها براءة الذئب من دم يوسف، كالعلمانية وحماية الأقليات والوحدة الوطنية وقضية فلسطين، وهي التي شكّلت أكبر تهديد لهذه القضايا طيلة فترة سيطرتها على الحكم؛ ليكون البديل حكماً استبدادياً يستند إلى مرجعية دينية متشددة؟
وهل كُتِب على الشعوب العربية العيش إما تحت حكم فردي استبدادي؟ أو تحت حكم ديني متشدد؟ وهل قَدَر هذه الشعوب هو الاختيار بين المرّ والأمرّ؟ وهل يمكن للجماعات الدينية ان تتبنى حكماً ديموقراطياً؟ ومع أننا لا نجزم بذلك أو ننفيه في ظل ما نراه على الساحة السورية اليوم، ولكن السؤال يبقى ملحّاً.
أم إنّ المجتمعات العربية “تدفع اليوم غالياً ثمن تغييب البرجوازية وإفقادها اعتبارها الأيديولوجي، ليس فقط على شكل أنظمة سلطوية فوقية تنزع إلى تأبيد نفسها في ((جمهوريات وراثية))، بل كذلك على شكل حركات شعبية، واعدة أو منذرة بشموليات من نوع جديد وأكثر جذرية بما لا يقاس في القطع مع الديموقراطية وقيم الحداثة. ففي ظل غياب البديل البرجوازي، فإن المعارضة الشبيهة للدكتاتوريات القائمة لابد أن تأخذ شكل صعود محتوم لمد الأصولية، ولا سيما في الشروط العينية للعالم العربي الذي يتحكم في مقاديره، منذ ما لا يقل عن ثلاثة عقود، التوظيف الأيديولوجي والثقافي للدولارات النفطية لصالح الأصولية الإسلامية.” ([1])
ما سبب تجذّر الاستبداد والدكتاتورية في ثقافتنا؟
في سعينا للبحث عن جذور هذا الاستبداد ورفض الآخر الكامن في الأنفس لدى شريحة واسعة من أبناء هذا المجتمع، عدنا إلى أسس التربية المتوارثة منذ مئات السنين بحثاً عن تفسير لذلك. ووجدنا أنه بين أهم الأسس التربوية المتوارثة، والتي مازالت فاعلة في مجتمعاتنا، ثلاثةٌ تمثّل ثالوث السُّبات الذي يعيشه العقل العربي، وهي النقل والحفظ والإملاء.
ونعيد تكرار السؤال لنجيب عليه: هل يمكننا أن نجد تفسيراً لهذا التأصيل الغريب للاستبداد والدكتاتورية في ثقافتنا؟
سنحاول التوقف عند كلٍّ من هذه الأقانيم الثلاثة، التي يتشكل وفقاً لها العقل العربي المسلم في القرن الواحد والعشرين، ونبيّن مدى تأثيرها على إمكانية انفتاح هذا العقل على مفاهيم تنتمي للعصر الراهن، ومدى تقبله لها، مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
ونحن إن كنا نرفض محاكمة الماضي بعيون الحاضر، فإننا نرى أن هذه الأسس، وإن كانت منسجمة ومتوافقة مع ما توصلت إليه البشرية في زمنها، فإنها لم تعد صالحة لزماننا؛ وغير متوافقة مع ما توصلت إليه البشرية من أسس تربوية في وقتنا الراهن. لذلك سنحاول أن نسلط الضوء على الأثر الذي ينتج عن الاصرار على اعتمادها من قِبل المنافحين عن التراث الديني على أنه الوصفة المقدسة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها.
ثالوث السبات الذي يعيشه العقل العربي الإسلامي!
الركن الأول النقل!
كما أسلفنا آنفاً فإن ثالوث السبات عندنا؛ الملازم للعقل العربي، له أضلاع ثلاثة وهي: النقل والحفظ والإملاء!
نبدأ بالضلع الأول؛ ونستدل على وجوده بالقاعدة الشهيرة التي تعلي من شأن النقل وتقدسه على حساب العقل، حيث لطالما تردّدت على مسامعنا عبارة: “النقل لا العقل”. وسنرى أثر تقديس هذا النقل وشرعنته وفقاً لأحاديث ومرويات تنسب لكبار الأئمة والوعّاظ. ولا شك بأن هذا التقديس يقابله تحقير وتعطيل للعقل، تلك الهبة التي منحها الله عز وجل للإنسان لتمييزه عن باقي المخلوقات.
ولأهمية النقل ظهر عند المسلمين “فن مصطلح الحديث، وفن الجرح والتعديل وتراجم الرجال. ولن نتعب القارئ المسلم بمحفوظات تتكرر على مسامعه أناء الليل وأطراف النهار عن درجات صحة الخبر ورتبه من جهة سلسلة السند، ومن جهة صاحب الخبر ومصدره، فعندها يغدو للصحيح درجات تبدأ من الظن القوي وتصل إلى الإدراك اليقيني.” ([2])
وهكذا يغدو: “العلم والبحث العلمي هو البحث عن حقيقة ضائعة في أحشاء الماضي. فلابد من استفتاء السلف جيلاً بعد جيل للوصول إليها. وأول شرط لذلك هو أن يكون هؤلاء السلف قد نقلوا إلينا الخبر الصحيح الذي يرتقي إلى مستوى اليقين.” ([3])
ومن بين الأحاديث التي تصادفنا في هذا الإطار، الحديث التالي: “عن علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسَحُ على ظاهر خفَّيْه).”
وهكذا، علينا أن نستنتج من هذا الحديث أن النقل مُقدَّمٌ على العقل لأننا لا نعرف لماذا مسح الرسول (ﷺ) على ظاهر خفَّيه!! وبافتراض صحة هذا الحديث، فهل يجوز أن يُعمَّم الاستنتاج الذي خرج به قائله على أمور الدين كافة؟ وهنا نودّ أن نوضّح أن تقديم النقل على العقل يتمّ؛ ولكن دون تمييز بين نصٍ إلهي وآخر بشري، بل إن النصوص تكتسب قدسيتها لمجرد تصنيفها، من قبل بشر مثلنا، على أنها من الأحاديث والمرويات الصحيحة، وطبعاً يختلف الصحيح بين مذهب وآخر.
الركن الثاني الحفظ!
ونتيجة لتقديس النقل على حساب العقل، يصبح الدور المناط بالعقل هو الحفظ فحسب، مما يعلي من قيمة الحفظ بوصفه المؤشر الأهم على مدى تميّز واجتهاد طالب العلم. وعلى المرء أن يحفظ كل ما يتلقّاه من المعارف المنقولة، دون نقاش أو إعمالٍ للعقل فيما يتلقاه.
وهذا يفسّر أيضاً كيف أضحى الأكثر حفظاً هو الأفضل، وهو من يرتقي بالمراتب العلمية. ولذلك، نجد أن لقب “الحافظ” يقترن بأسماء كثيرٍ من أعلام الأمة من محدثين ورواة ومفسّرين للدلالة على مكانتهم العلمية، وكأنها رتبة علمية تضفي على صاحبها مكانة تشبه تلك التي يضفيها لقب بروفيسور في أيامنا هذه.
ونورد فيما يلي بعض أسماء كبار الأئمة والمحدثين الذين اقترن اسمهم بهذا اللقب على سبيل المثال لا الحصر: الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي، والحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، والحافظ شمس الدين الذهبي، والحافظ ثقة الدين أبو القاسم الدمشقي، الخ.
الركن الثالث الإملاء!
نتيجة لتقديس النقل وتقليص دور العقل إلى الحفظ فحسب، يكون الإملاء، دون أي مراجعة أو سؤال، هو الطريقة الوحيدة المتاحة لنقل المعرفة. فقدسية النص المنقول تمنح الإملاء سطوته، ويكون دور المتلقي هو حفظ النص كما وصله. وفي ظل هكذا منهجية، يكتسب الإملاء أهمية لا تقل عن نظيريه السابقين، النقل والحفظ، مستمدة من تقديس النص المنقول وأهمية حفظه كما هو. ولا سبيل أمام متلقي هذه المعرفة إلى طرح أي سؤال أو التحقق من أية معلومة أو مراجعة أية فكرة وردت في النص، المقدس طبعاً!
ولكن إن توقفنا عند لفظة “الإملاء” في اللغة العربية، وقارنّاها مع نظيرتها في اللغة الإنكليزية، لوجدنا أن المقابل لها هو دِكتيشن (Dictation). أما من يملي المعلومات والمعارف، فيدعى دِيكتيتر(Dictator). لنجد أن هذه اللفظة هي نفسها التي عُرِّبت إلى العربية لوصف المستبد، وهي لفظة دكتاتور. والدكتاتور هو الشخص الذي لا يقبل رأياً مخالفاً ولا يخضع للمساءلة، وهو دائماً على صواب.
نتائج هذا الثالوث على العقل المسلم!
والآن نتساءل: أليست هذه الصفات نفسها التي يتّصف بها النص التراثي المنقول؟! أليس التأكيد على أن ما وصلنا من الأجداد غير قابل للشك أو المساءلة، هو ديدن رجال الدين؟ ألم يكن أي سؤال أو استفسار حول الموروث الديني، كفيلاً بتكفير صاحب هذا السؤال أو الاستفسار؟
وطبعاً الإجابة على كل هذه الأسئلة هي نعم، مما يجعلنا نقول دون تردد أن جذور الاستبداد موجودة داخل ثقافتنا. لذلك ترانا ننظر بعين الشك والريبة إلى طروحات بعض الجماعات الإسلامية حول الحرية، لأنها محكومة بثالوث الاستبداد الذي أشرنا إليه آنفاً، النقل والحفظ والإملاء.
وبناءً على ما ذكر، ألا يمكننا القول إن تأصيل الاستبداد يستمد مشروعيته من الأسس التربوية التي يروّج لها المدافعون عن قدسية هذا التراث دون تمييز بين الإلهي والبشري، ودون النظر إلى اختلاف الزمان والمكان الذي نشأت فيه هذه الأسس؟ ونحن إن كنا ننظر إلى نص التنزيل الحكيم بوصفه نصّاً مقدساً، فإننا نحذّر من اضفاء هذه القدسية على نصوص أخرى؛ أنتجها بشرْ، مهما علت مكانتهم في التاريخ الإسلامي.
وما حصل مع الجماعات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بعض الدول العربية والإسلامية، سواء تلك التي ما زالت في السلطة؛ أم تلك التي تم الانقلاب عليها، يوضّح المأزق الحضاري الذي واجهته هذه الجماعات في محاولتها لحكم مجتمعاتها.
فعندما وصلت هذه الجماعات إلى السلطة، أرادت أن تطبق الدين الذي تعتقد بأنه صالح لكل زمان ومكان. ولكنها كانت تطبق الموروث الديني الذي وصلنا من السلف، وهي تعتقد أنه صحيح تماماً ولا يخضع للمساءلة أو المراجعة، مضفيةً عليه صفة القدسية التي تضفيها على نص الوحي، دون أن تميّز بين نص الوحي؛ وما ورثناه عن الآباء نتيجة تفاعلهم مع هذا النص المُوحى. فنتج عن ذلك خطاب أحادي لا يقبل المخالف ويرفض الآخر ويكفّره، فكانت النتيجة أزمات وكوارث أصابت هذه الدول، وبعضها لا يزال يعاني منها إلى اليوم.
الحرية هي الضحية
إذا كانت كلمة الحرية بالمعنى المستخدم اليوم، والمرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وما إلى هنالك من حقوق للإنسان، خارج دائرة المفكر فيه بالنسبة للسلف الذين أنتجوا هذا التراث، فإنه يتوجب علينا اليوم أن ننظر إلى التراث بوصفه منتجاً بشرياً نسبياً محدوداً بزمنه وظروفه المعرفية، وأن نتوقف عن تقديسه، وأن نؤدي دورنا، وذلك بالتفاعل مع النص المؤسس، نص التنزيل الحكيم، وفقاً لزماننا وظروفنا والأرضية المعرفية التي نقف عليها. وعليه، عندما تطالعنا الآية (29) من سورة الكهف، نرى في قوله تعالى:﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، بأن الإنسان له كامل الحق في أن يؤمن أو أن يكفر، أي أن التنزيل الحكيم وفقاً لهذه الآية يؤكد على حرية الإنسان حتى بالكفر.
وإن عدنا إلى الفهم المعاصر لنص التنزيل الحكيم، لوجدنا أن الحرية موجودة في القرآن وهي الكلمة التي سبقت لكل أهل الأرض. وأن الأساس في الحياة هو الإختلاف والتعدد، كما في الآية (118) من سورة هود: ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ﴾. وتعريف “لو” التي بدأت بها الآية هو حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، أي أن المشيئة لجعل الناس أمة واحدة لم تحصل، وبالتالي فهم مختلفين، وسيبقون مختلفين إلى يوم الدين.
ثم تؤكد الآية التي تليها على أن الإختلاف حتمي، بل هو غاية الخلق: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ﴾. وهذا الإختلاف يؤدي بالضرورة إلى تعدد الآراء والأفكار والمعتقدات، والتي يجب أن تكون مصانة في أي مجتمع تكون كلمة الله فيه هي العليا.([4]) فلا يمكن أن يختلف الناس فيما بينهم دون أن تكون حريتهم مصانة، والإختلاف هو مشيئة الله – جل جلاله. ونرى هذا جليا في الآية (19) من سورة يونس: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَٱخۡتَلَفُواْۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ فِيمَا فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾. وهذا يعني أن كلمة الله قد سبقت في جعلهم أحراراً، وهذا أدى إلى الاختلاف بينهم، لذلك نجد تلازماً بين غاية الخلق﴿وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ﴾ والحرية.([5])
المراجع
[1] ـ 1 جورج طرابيشي هرطقات. دار الساقي بالاشتراك مع رابطة العسقلانيين العرب، بيروت 2006، ص: 13.
[2] ـ محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر المعاصر، دمشق 1993، ص: 35. نقلاً عن: عبد الرزاق عيد، سدنة هياكل الوهم – البوطي
نموذجاً، دار الطليعة، بيروت 2003، ص: 25.
[3] ـ محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر المعاصر، دمشق 1993، ص: 35. نقلاً عن: عبد الرزاق عيد، سدنة هياكل الوهم – البوطي
نموذجاً، دار الطليعة، بيروت 2003، ص: 25.
[4] محمد شحرور، الدين والسلطة – قراءة معاصرة للحاكمية، دار الساقي، بيروت 2014 ، ص 269
[5] المصدر السابق ص 270